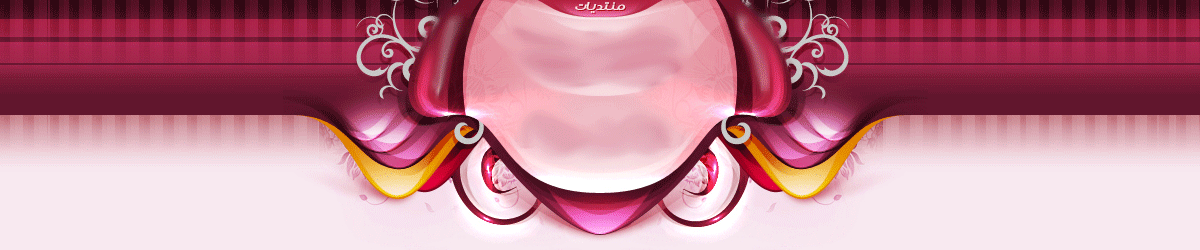مالك بن نبي
اقتناع النبي الشخصي بالنبوة
إن ((محمداً)) أمي، ليس لديه من معرفة البشر سوى ما يمكن أن يمنحه له وسطه الذي ولد فيه.
وفي هذا الوسط الفروسي، الوثني، البدوي، لا مجال مطلقاً للمشكلات الاجتماعية والغيبية (الميتافيزيقية)، فإن معارف العرب عن الحياة الاجتماعية والفكرية لدى الشعوب الأخرى ليست بذات قيمة، إذا ما رجعنا إلى الشعر الجاهلي الذي يعتبر مصدراً قيماً للمعلومات في هذا الموضوع.
فمحمد في ذهابه إلى عزلته في غار حراء لم يكن لديه سوى ذلك المتاع العادي من الأفكار الشائعة في وسطه البدائي.
ثم تأتي الفكرة الموحي بها فتقلب هذه المعرفة الضئيلة المحاطة بسياج مزدوج من الجهل العام، والأمية الخاصة عند محمد.
ومن الواجب أن نتصور في كلمة ((اقرأ)) وهي الكلمة الأولى للوحي، تأثيرها الصاعق على النبي حيث إنها لا تعني شيئاً بالنسبة له، إذ هو أمي. وهذا الأمر الملزم يحدث بطبيعة الحال انقلاباً في كيانه، لأنه يزلزل فكرة الأمي عن نفسه، فيجيب متهيباً: (ما أنا بقارئ). ولكن ... أي صدمة مذهلة تصيب فكره الموضوعي .. ؟!. فإذا كان النبي قد تخلقت لديه نواة الاقتناع عقب الملاحظات الأولى المذكورة، فإن هذه الصدمة العقلية لن تبدد شكوكه مرة واحدة، إذ عندما يأمره الصوت في المرة التالية (أن ينذر)، سيتساءل قلقاً ((مَن ذا الذي يؤمن بي؟)) وفي هذا السؤال نلمح مفاجأة الشيء غير المتوقع، وحيرة الاقتناع.
وفضلاً عن ذلك فإن الوحي سينقطع فترة من الزمن، وسنجد أنه يتمناه، بل يريده، بل يناديه مستيئساً، ولا من مجيب.
هنا يجد ((محمد)) نفسه في أقسى لحظات أزمته الأدبية التي عرفها في غار حراء. وهنا يتعاظم شكه، وقد كان يسيراً، فيشكو حيرته لزوجته الحانية، وإذا بها تحاول أن تعزيه بكلمات لا تبعث في قلبه العزاء ... وأخيراً وبعد عامين ينزل الوحي، فيأتيه بالكلمة العليا، الوحيدة، التي هي بلسم الشفاء ... كلمة الله.
لقد أشرقت أسارير النبي، إذ هو يملك منذ الآن البرهان الأدبي والعقلي على أن الوحي لا يصدر عن ذاته، ولا يوافيه طوع إرادته، فلقد بدا له عصياً لا يمكن أن يخضع له، كما لا تخضع له أفكار الآخرين وكلماتهم. ولديه الآن برهان موضوعي إلى أقصى درجة على صحة اقتناعه الجديد.
هذا الانتظار الحزين، ثم ما تلاه من ابتهاج مفاجئ كانا ـ في الواقع ـ الظرفين النفسيين المناسبين لتلك الحالة من الفيض العقلي، حيث لم تعد تخطر ظلال الريبة والشك.
والحق أن الشك الذي عاناه النبي (ص) هو الذي اضطره إلى أن ينكب على حالته الخاصة، ويواصل تفكيره ومعالجته التي ستنتهي باليقين النهائي.
وفي هذا التحول نرى أثرا لتربية السامية، التي تعين رسول الله على أن يتحقق تدريجياً في نفسه من حقيقة الظاهرة القرآنية، يعينه على ذلك تكيف مستمر لضميره الواعي، وكأنما أريد إعداده منهجياً للاقتناع الجديد، ثمرة الفكرة الناضجة المستغرقة، وهو اقتناع يتجلى في محاوراته الأولى مع قريش، لقد تبدلت حال نفسه، فأصبح يثق في ذاته، وينزل الوحي لكي يعكس على نظرنا حاله النفسية الجديدة، ويؤكد هذا الاقتناع الظافر بقوله:
(والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى ... ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآة نزلة أخرى ... ) النجم الآيات 1 ـ 4، 11 ـ 13.
لم يعد لدى النبي أدنى شك أدبي أو عقلي، فإن الحكم الصادق هو الذي يهديه، وهذا النوع من الحكم لا يحول الشك المنهجي الذي عاناه، إلى شك مقصود لذاته. إذ أن الحقيقة العلوية للوحي تفرض نفسها فرضاً على العقل الوضعي. فكل ما يراه، وما يسمعه، وما يشعر به، وما يفهمه يتفق الآن مع حقيقة واضحة تماماً في ذهنه، جلية في عينيه هي: الحقيقة القرآنية.
وأكثر من ذلك فإن إدراكه في هذا النطاق سيزداد ويتسع كلما تابع الوحي آياته البليغة، تلك التي تكون الكتاب الروحي الذي أحس به مطبوعاً في قلبه في غار حراء، وإن هذا الاقتناع العقلي ليزداد رسوخاً كلما ازدادت الهوة عمقاً في عينيه بين ظنون ((الإنسان)) وما يجري على لسان ((النبي)).
وسيتابع الوحي نزوله بسور القرآن سورة سورة، فتتزاحم في وعيه الحقائق التاريخية، والكونية، والاجتماعية التي لم يسبق أن سجلت في صفحة معارفه، بل حتى في معارف عصره، ومناحي اهتمامه.
هذه الحقائق ليست مجرد تعميمات غامضة، ولكنها معلومات محددة تضم تفاصيل هامة عن تاريخ الوحدانية.
فقصة يوسف المفصلة، مثلاً، أو التاريخ المفصل لهجرة بني إسرائيل لا يمكن اعتبارهما مجرد اتفاق عارض، بل يجب حتماً أن يأخذا لدى ((محمد)) (ص) صفة الوحي العلوية.
ولنا أن نتساءل كيف استطاع أن يدرك الاتفاق العجيب لهذا الوحي مع ما ورد من التفاصيل التاريخية في التوراة ... ؟
لقد كان يكفي محمداً لاقتناعه الشخصي أن يلاحظ أن مثل هذا التفصيل غير المتوقع، والذي غاب عن الأعين في طيات التاريخ ليس بذي طابع شخصي، دون أن يستخدم فعلاً أساساً للمقارنة، حتى يحكم على الفكرة الموحاة، ومدى تصديقها لما ورد في التوراة.
فكان عليه أن يلاحظ أن أخبار الوحي تنزل عليه من مصدر ما، فمن هو هذا المصدر؟. صار إذن من اللازم أن يحتل هذا السؤال مكانه في العملية العقلية التي يستقي منها النبي إدراكه الثابت، واقتناعه الشخصي. ولقد جاءت إجابته عن هذا السؤال بعد مقابلة باطنية بين فكرته الشخصية وبين الحقيقة المنزلة، وكان بحسبه أن يعقد هذه المقابلة لكي يحل مصدر هذه الأخبار المنزلة، خارج ذاته، وخارج مجتمعه، فما كان لديه أي التباس في هذا، فخارج معلوماته لم يكن يستطيع أن يجد الحقيقة القرآنية عند أي مصدر إنساني.
و ((محمد)) صادق مع قومه، وهو قبل ذلك صادق مع نفسه، فدراسته الواعية لحالته الغريبة يجب أن تكون نوعاً من الدرس الباطني القرآني. بحيث تقضي هذه الدراسة على أي شكل يخايل عينيه، ما دام يمكنه أن يجريها على أساس منهجين مختلفين، الأول: ذاتي محض يقتصر على ملاحظته وجود الوحي خارج الإطار الشخصي، والثاني: موضوعي يقوم على المقارنة الواقعية بين الوحي المنزل وما ورد من التفاصيل المحددة في كتب اليهود والنصارى مثلاً.
وكأنما كان الوحي ـ أحياناً ـ يعلمه هذا المنهج الأخير الموضوعي عندما لا يكون الأمر أمر اقتناعه هو ـ حيث إنه اقتنع منذ زمن طويل ـ بل أمر تأسيس وتربية للذات المحمدية، ولا سيما عندما يجادل المشركين عن عقيدته، أو وفود النصارى الآتية من أطراف الجزيرة، كوفد نجران الذي أتاه ليناقش معه عقيدة التثليث.
وفي هذا يحدثه الوحي صراحة:
(فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين) يونس آية 94.
يحدثنا المفسر جلال الدين السيوطي فيقول:
إن النبي عقب على ذلك قائلاً: ((لا أشك ولا أسأل)).
فمن هذا نرى أن النبي كان يمكنه أن يكتفي بالمقابلة الباطنية المشار إليها آنفاً، على الأقل فيما يتصل باقتناعه الشخصي. ولكن كان عليه أيضاً أن يشبع حاجة الآخرين إلى الاقتناع، فكأنما قد استخدم لذلك المنهج الثاني عندما كان يتصدى في إحدى المناظرات العامة لتحقيق قيمة الوحي بصفة موضوعية بالنسبة لحقيقة مكتوبة في الكتب السابقة.
وتلك ـ على ما نظن ـ المناسبة التي نزلت من أجلها سورة يوسف، فكما قرر الزمخشري: نزلت هذه السورة المكية عقب نوع من التحدي الذي جابهه به علماء بني إسرائيل، لقد سألوه صراحة عن قصة يوسف، فنزلت ولكنها إذا كانت قد أجابت على تحد صادر عن أحبار اليهود أو غيرهم، فإنها لم تكن لتحسم النزاع إلا بمقابلة دقيقة بين نصوص التوراة وقصص القرآن.
ولا شك أن النبي لم يكن في نفسه مهتماً بمثل هذه المقابلة، التي تتيح له فرصة المقارنة الموضوعية بين الوحي والتاريخ الثابت في كتب بني إسرائيل. ولعل هذه الفرصة لم تكن الوحيدة التي لجأ فيها إلى المقارنة الفعلية، التي تقدم في كل مرة عنصراً جديداً لمقياس اقتناعه العقلي.
وأخيراً، فإن صوغ هذا الاقتناع، يبدو أنه قد سار طبقاً لمنهج عادي حين ضم ـ من ناحية ـ الملاحظات المباشرة للنبي عن حالته، ومن ناحية أخرى مقياساً عقلياً يستقي منه اقتناعه، وهو يجول بعقله في دقائق ملاحظاته.
إن علم الدراسات الإسلامية الذي يتناول هذه الدراسات في عمومها بفكر مغرض، لم يعالج مشكلة هذا الاقتناع الشخصي، برغم أنها في المقام الأول من الأهمية لتفهم الظاهرة القرآنية، إذ هو يمثل مفتاح المشكلة القرآنية حين نضعها على البساط النفسي للذات المحمدية.
وغني عن البيان أنه لكي يؤمن ((محمد))، ويستمر على الإيمان بدعوته يجب ن نقرر حسب تعبير (أنجلز) أن كل وحي لابد أن يكون قد ((مر بوعيه)) واتخذ في نظره صورة مطلقة، غير شخصية، ربانية في جوهرها الروحي، وفي الطريقة التي تظهر بها.
ومحمد (ص) قد حفظ ـ بلا أدنى شك ـ اعتقاده حتى تلك اللحظة العلوية، حتى تلك الكلمة الأخيرة:
((نعم ... في الرفيق الأعلى)).
اقتناع النبي الشخصي بالنبوة
إن ((محمداً)) أمي، ليس لديه من معرفة البشر سوى ما يمكن أن يمنحه له وسطه الذي ولد فيه.
وفي هذا الوسط الفروسي، الوثني، البدوي، لا مجال مطلقاً للمشكلات الاجتماعية والغيبية (الميتافيزيقية)، فإن معارف العرب عن الحياة الاجتماعية والفكرية لدى الشعوب الأخرى ليست بذات قيمة، إذا ما رجعنا إلى الشعر الجاهلي الذي يعتبر مصدراً قيماً للمعلومات في هذا الموضوع.
فمحمد في ذهابه إلى عزلته في غار حراء لم يكن لديه سوى ذلك المتاع العادي من الأفكار الشائعة في وسطه البدائي.
ثم تأتي الفكرة الموحي بها فتقلب هذه المعرفة الضئيلة المحاطة بسياج مزدوج من الجهل العام، والأمية الخاصة عند محمد.
ومن الواجب أن نتصور في كلمة ((اقرأ)) وهي الكلمة الأولى للوحي، تأثيرها الصاعق على النبي حيث إنها لا تعني شيئاً بالنسبة له، إذ هو أمي. وهذا الأمر الملزم يحدث بطبيعة الحال انقلاباً في كيانه، لأنه يزلزل فكرة الأمي عن نفسه، فيجيب متهيباً: (ما أنا بقارئ). ولكن ... أي صدمة مذهلة تصيب فكره الموضوعي .. ؟!. فإذا كان النبي قد تخلقت لديه نواة الاقتناع عقب الملاحظات الأولى المذكورة، فإن هذه الصدمة العقلية لن تبدد شكوكه مرة واحدة، إذ عندما يأمره الصوت في المرة التالية (أن ينذر)، سيتساءل قلقاً ((مَن ذا الذي يؤمن بي؟)) وفي هذا السؤال نلمح مفاجأة الشيء غير المتوقع، وحيرة الاقتناع.
وفضلاً عن ذلك فإن الوحي سينقطع فترة من الزمن، وسنجد أنه يتمناه، بل يريده، بل يناديه مستيئساً، ولا من مجيب.
هنا يجد ((محمد)) نفسه في أقسى لحظات أزمته الأدبية التي عرفها في غار حراء. وهنا يتعاظم شكه، وقد كان يسيراً، فيشكو حيرته لزوجته الحانية، وإذا بها تحاول أن تعزيه بكلمات لا تبعث في قلبه العزاء ... وأخيراً وبعد عامين ينزل الوحي، فيأتيه بالكلمة العليا، الوحيدة، التي هي بلسم الشفاء ... كلمة الله.
لقد أشرقت أسارير النبي، إذ هو يملك منذ الآن البرهان الأدبي والعقلي على أن الوحي لا يصدر عن ذاته، ولا يوافيه طوع إرادته، فلقد بدا له عصياً لا يمكن أن يخضع له، كما لا تخضع له أفكار الآخرين وكلماتهم. ولديه الآن برهان موضوعي إلى أقصى درجة على صحة اقتناعه الجديد.
هذا الانتظار الحزين، ثم ما تلاه من ابتهاج مفاجئ كانا ـ في الواقع ـ الظرفين النفسيين المناسبين لتلك الحالة من الفيض العقلي، حيث لم تعد تخطر ظلال الريبة والشك.
والحق أن الشك الذي عاناه النبي (ص) هو الذي اضطره إلى أن ينكب على حالته الخاصة، ويواصل تفكيره ومعالجته التي ستنتهي باليقين النهائي.
وفي هذا التحول نرى أثرا لتربية السامية، التي تعين رسول الله على أن يتحقق تدريجياً في نفسه من حقيقة الظاهرة القرآنية، يعينه على ذلك تكيف مستمر لضميره الواعي، وكأنما أريد إعداده منهجياً للاقتناع الجديد، ثمرة الفكرة الناضجة المستغرقة، وهو اقتناع يتجلى في محاوراته الأولى مع قريش، لقد تبدلت حال نفسه، فأصبح يثق في ذاته، وينزل الوحي لكي يعكس على نظرنا حاله النفسية الجديدة، ويؤكد هذا الاقتناع الظافر بقوله:
(والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى ... ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآة نزلة أخرى ... ) النجم الآيات 1 ـ 4، 11 ـ 13.
لم يعد لدى النبي أدنى شك أدبي أو عقلي، فإن الحكم الصادق هو الذي يهديه، وهذا النوع من الحكم لا يحول الشك المنهجي الذي عاناه، إلى شك مقصود لذاته. إذ أن الحقيقة العلوية للوحي تفرض نفسها فرضاً على العقل الوضعي. فكل ما يراه، وما يسمعه، وما يشعر به، وما يفهمه يتفق الآن مع حقيقة واضحة تماماً في ذهنه، جلية في عينيه هي: الحقيقة القرآنية.
وأكثر من ذلك فإن إدراكه في هذا النطاق سيزداد ويتسع كلما تابع الوحي آياته البليغة، تلك التي تكون الكتاب الروحي الذي أحس به مطبوعاً في قلبه في غار حراء، وإن هذا الاقتناع العقلي ليزداد رسوخاً كلما ازدادت الهوة عمقاً في عينيه بين ظنون ((الإنسان)) وما يجري على لسان ((النبي)).
وسيتابع الوحي نزوله بسور القرآن سورة سورة، فتتزاحم في وعيه الحقائق التاريخية، والكونية، والاجتماعية التي لم يسبق أن سجلت في صفحة معارفه، بل حتى في معارف عصره، ومناحي اهتمامه.
هذه الحقائق ليست مجرد تعميمات غامضة، ولكنها معلومات محددة تضم تفاصيل هامة عن تاريخ الوحدانية.
فقصة يوسف المفصلة، مثلاً، أو التاريخ المفصل لهجرة بني إسرائيل لا يمكن اعتبارهما مجرد اتفاق عارض، بل يجب حتماً أن يأخذا لدى ((محمد)) (ص) صفة الوحي العلوية.
ولنا أن نتساءل كيف استطاع أن يدرك الاتفاق العجيب لهذا الوحي مع ما ورد من التفاصيل التاريخية في التوراة ... ؟
لقد كان يكفي محمداً لاقتناعه الشخصي أن يلاحظ أن مثل هذا التفصيل غير المتوقع، والذي غاب عن الأعين في طيات التاريخ ليس بذي طابع شخصي، دون أن يستخدم فعلاً أساساً للمقارنة، حتى يحكم على الفكرة الموحاة، ومدى تصديقها لما ورد في التوراة.
فكان عليه أن يلاحظ أن أخبار الوحي تنزل عليه من مصدر ما، فمن هو هذا المصدر؟. صار إذن من اللازم أن يحتل هذا السؤال مكانه في العملية العقلية التي يستقي منها النبي إدراكه الثابت، واقتناعه الشخصي. ولقد جاءت إجابته عن هذا السؤال بعد مقابلة باطنية بين فكرته الشخصية وبين الحقيقة المنزلة، وكان بحسبه أن يعقد هذه المقابلة لكي يحل مصدر هذه الأخبار المنزلة، خارج ذاته، وخارج مجتمعه، فما كان لديه أي التباس في هذا، فخارج معلوماته لم يكن يستطيع أن يجد الحقيقة القرآنية عند أي مصدر إنساني.
و ((محمد)) صادق مع قومه، وهو قبل ذلك صادق مع نفسه، فدراسته الواعية لحالته الغريبة يجب أن تكون نوعاً من الدرس الباطني القرآني. بحيث تقضي هذه الدراسة على أي شكل يخايل عينيه، ما دام يمكنه أن يجريها على أساس منهجين مختلفين، الأول: ذاتي محض يقتصر على ملاحظته وجود الوحي خارج الإطار الشخصي، والثاني: موضوعي يقوم على المقارنة الواقعية بين الوحي المنزل وما ورد من التفاصيل المحددة في كتب اليهود والنصارى مثلاً.
وكأنما كان الوحي ـ أحياناً ـ يعلمه هذا المنهج الأخير الموضوعي عندما لا يكون الأمر أمر اقتناعه هو ـ حيث إنه اقتنع منذ زمن طويل ـ بل أمر تأسيس وتربية للذات المحمدية، ولا سيما عندما يجادل المشركين عن عقيدته، أو وفود النصارى الآتية من أطراف الجزيرة، كوفد نجران الذي أتاه ليناقش معه عقيدة التثليث.
وفي هذا يحدثه الوحي صراحة:
(فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين) يونس آية 94.
يحدثنا المفسر جلال الدين السيوطي فيقول:
إن النبي عقب على ذلك قائلاً: ((لا أشك ولا أسأل)).
فمن هذا نرى أن النبي كان يمكنه أن يكتفي بالمقابلة الباطنية المشار إليها آنفاً، على الأقل فيما يتصل باقتناعه الشخصي. ولكن كان عليه أيضاً أن يشبع حاجة الآخرين إلى الاقتناع، فكأنما قد استخدم لذلك المنهج الثاني عندما كان يتصدى في إحدى المناظرات العامة لتحقيق قيمة الوحي بصفة موضوعية بالنسبة لحقيقة مكتوبة في الكتب السابقة.
وتلك ـ على ما نظن ـ المناسبة التي نزلت من أجلها سورة يوسف، فكما قرر الزمخشري: نزلت هذه السورة المكية عقب نوع من التحدي الذي جابهه به علماء بني إسرائيل، لقد سألوه صراحة عن قصة يوسف، فنزلت ولكنها إذا كانت قد أجابت على تحد صادر عن أحبار اليهود أو غيرهم، فإنها لم تكن لتحسم النزاع إلا بمقابلة دقيقة بين نصوص التوراة وقصص القرآن.
ولا شك أن النبي لم يكن في نفسه مهتماً بمثل هذه المقابلة، التي تتيح له فرصة المقارنة الموضوعية بين الوحي والتاريخ الثابت في كتب بني إسرائيل. ولعل هذه الفرصة لم تكن الوحيدة التي لجأ فيها إلى المقارنة الفعلية، التي تقدم في كل مرة عنصراً جديداً لمقياس اقتناعه العقلي.
وأخيراً، فإن صوغ هذا الاقتناع، يبدو أنه قد سار طبقاً لمنهج عادي حين ضم ـ من ناحية ـ الملاحظات المباشرة للنبي عن حالته، ومن ناحية أخرى مقياساً عقلياً يستقي منه اقتناعه، وهو يجول بعقله في دقائق ملاحظاته.
إن علم الدراسات الإسلامية الذي يتناول هذه الدراسات في عمومها بفكر مغرض، لم يعالج مشكلة هذا الاقتناع الشخصي، برغم أنها في المقام الأول من الأهمية لتفهم الظاهرة القرآنية، إذ هو يمثل مفتاح المشكلة القرآنية حين نضعها على البساط النفسي للذات المحمدية.
وغني عن البيان أنه لكي يؤمن ((محمد))، ويستمر على الإيمان بدعوته يجب ن نقرر حسب تعبير (أنجلز) أن كل وحي لابد أن يكون قد ((مر بوعيه)) واتخذ في نظره صورة مطلقة، غير شخصية، ربانية في جوهرها الروحي، وفي الطريقة التي تظهر بها.
ومحمد (ص) قد حفظ ـ بلا أدنى شك ـ اعتقاده حتى تلك اللحظة العلوية، حتى تلك الكلمة الأخيرة:
((نعم ... في الرفيق الأعلى)).